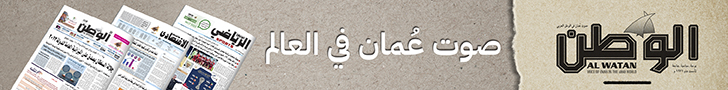البنى العميق للنص ومحاولة الوصول للمكن
والأسئلة الملحة الآن ، لماذا التنوع الإيقاعي في البنية الأساسية للنص ؟ وهل تناسب هذا التنوع الإيقاعي والحالات الانتقالية من أسلوب لأسلوب ؟ وهل استطاع التنوع خدمة الغاية الجمالية للعملية الانتقالية للانفعال ؟ .
ففي المقطع الأول من مطلع النص نجد التفعيلة الأساسية للكامل ( مُتَفاعِلُنْ ) بنوعيها كدال على الحركة الداخلية للجملة المسلطة على الحركة الداخلية للنفس ، حيث تقوم الجملة على ثلاث محاور تقابلها حركتان ، الأول امتلاك ( لي ما ) والثاني توالي ( يبرر وحشتي ) والثالث انصباب ( هذا الصباح ) ، ما يعني بالضرورة اختلاف نوع الحركة وبالتالي شكل التفعيلة الحاملة للحركة ، فحيث الامتلاك والانصباب تكون الحدة ( مُيْفاعِلُنْ ) ، وحيث التوالي تكون الانسيابية ( مُتَفاعِلُنْ ) ، فيكون السطر الشعري ( لي ما يبرر وحشتي هذا الصباح / امتلاك ـ توالي ـ انصباب / مُتْفاعِلُنْ ـ متَفاعِلُنْ ـ مُتْفاعِلُنْ ) .
امّا التنوع بين تفعيلتين بناء على التدوير ، فيكون واضحا شديد الوضوح في المقطع الثاني من الضلع الأول القاعدي للنص ، حيث التحول من ( لي ما يبررها ـ متْفاعِلنْ ـ متفا ) إلى التفعيلة الراقصة والمسيرة للحكاية وتوالي السرد بنوعيها ( مُفاعَلَتُنْ ـ مفاعلْتُنْ / مفاعيلن ) وحسب نوع حركة السرد لشخوص الحكاية أو التصاعد الدرامي فيها ، فالشكوى راقصة حادة ، والمعاناة راقصة منسابة في النفس البشرية ( فأمي تشتكي صمما وقد عشيت ) والجملة لها أيضا محوران ، الأول شكوى ، والثانية وصف معاناة لتتكون الجملة من تفعيلتي مفاعلتن للوافر وتصبح كالتالي ( فأمْ مي تش ـ مفاعيلن ـ شكوى / تكي صمما ـ معاناة ـ مفاعَلَتنْ / وقد عشيتْ ـ معاناة ـ مفاعلَتَنْ ) ، كذلك الحيرة تقترب من الشكوى ، بجانب الاتصال الذي يصف بالحدة والهاتف يكوت كالتوالي منساب فيكون السطر الشعري والتنوع المناسب لحركة السرد ( لماذا لا أكفّ عن اتصالي الهاتفيّ بها ) وعليه نجد الوصف الحركي للجملة كالتالي ( حيرة ـ لماذا لا ـ مفاعيلن / توالي محاولات ـ أكف فعنت ـ مفاعَلَتُنْ / حركة الاتصال الحادة ـ تصالل ها ـ مفاعيلن / والاتصال ذاته منساب ـ تفي ي بها ـ مفاعَلَتَنْ ) ، ثم ينتهي المقطع بالتفعيلة الأم كنوع من التحول من السرد للتأمل .
إلا أن هناك تفعيلة ثالثة داخلة في البنية الإيقاعية للنص وتأتي نتيجة تقنية التدوير أيضا ، ونقصد بها تفعيلة ( مُتَفْعِلُنْ ) ، وهي تقتصر على الجملة التعليلية ، كنتيجة حتمية للجملة الرئيسة ( لي ما يبرر ) وكانت على التوالي في الضلع الأول مقاطع ( 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ) ( فإن جا / ولم يكن / فلم ترث / كأنْ أصيغ / وأن أعيد / ولا أمل ) والضلع الثاني مقطع رقم ( 1 ) ولعل ندرتها في هذا الضلع يؤكد على ما ذهبنا إليه ، حيث تختص بالبداية التعليلية للمقطع لا غير ولا تتعداها لغيرها ، ثم الضلع الثالث مقطعا ( 3 ـ 4 ) وخاصة المقطع الرابع الممتلئ بالتعليل .
إذا فالبنية الإيقاعية في النص كنتيجة نهائية قائمة على صفة الثنائية لتفعيلتي ( مُتَفاعِلُنْ ـ / / / 0 / / 0 و مُفاعَلَتُنْ / / 0 / / / 0 ) التبادلية في الحركات بين الانسيابية والرقص ، وكذلك الثنائية التناقضية بين التفعيلة الواحدة في ( مُتَفاعِلُنْ / / / 0 / / 0 الانسيابية و مُتْفاعِلُنْ / مُسْتَفْعِلُنْ / 0 / 0 / / 0 الحادة ) وبين تفعيلة ( مُفاعَلَتُنْ / / 0 / / / 0 الراقصة المنسابة و مُفاعَلْتُنْ / مفاعيلن / / 0 / 0 / 0 الراقصة بحزم أو حدّة ) وخاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار رؤية العروضيين المحدثين لتفعيلتي ( مفاعلتن ومفاعلين ) اللتان يرونها تفعيلة واحدة ( يرجع إلى ذلك في كتاب موسيقى الشعر بين الإتباع و الإبداع للدكتور شعبان صلاح البحر الوافر
الثنائيات والبنية الدلالية للنص :
فإذا كانت آلية البنيوية تهدف للكشف عن المعنى الممكن لا الكامل ( فحسبه أن يصل إلى الممكن من المعنى ) صلاح فضل / البنائية ، وتعتمد على الكثير من المقاربات سواء التفكيكية منها أو التقابلية ، فإن أهم هذه الآليات المستخدمة هي الكشف عن ثنائيات النص أو الصفة التقابلية كما يحلو للدكتور / عبد القادر عبو أن يسميها ، والتي اعتمد عليها كثير من البنيويين العرب أمثال الدكتور كمال الدين أبو ديب في جدلية الخفاء والتجلي ويمنى العيد في تحليلها البنيوي لنص الفاروق عمر رضي الله عنه أو الدكتور عبد الله الغذامي ، وعلى اعتبار أن تلك الثنائيات أو التقابلات تنشئ جلدية سواء أكانت ضدية كما كانت مع كمال الدين أبو ديب أو جدلية الداخل والخارج مع يمنى العيد أو نمو حركة السرد مع الغذامي .
فإذا ما اتجهنا إلى بنى النص المختلفة لوجدنا عددا من الثنائيات أو التقابلات التي يعتمد عليها النص في الكشف عن أبعاد الوحشة ، وبالتالي انتقالية الانفعال كغاية جمالية بواسطة اعتماده على استراتيجية السرد والخطاب المباشر ، والذي يعد في حد ذاته سمة أساسية ، حيث يعتمد السرد على الحوارية بين صوتين ، الأول منها واضح ويصدر من النص ذاته ، والثاني منها خفي مستنتج يتوقعه النص من القارئ حيث يصبح القارئ طرفا أساسيا في الإبداع الثاني ، فإن كانت الحوارية عند ( باختين ) ( تظهر من خلال أصوات متعددة تتكلم في الوقت ذاته ، دون أن يتغلب أحدهما على الآخر ) فإن النص لا يريد لنا أن نميل ، بل يريد التفاعل مع هذه الحوارية ونشارك في الجدلية لنصبح الطرف الخفي للحوارية ، ليحدث كما يقرر الدكتور أحمد مطلوب ( مسافة التوتر التي تخلق النص ذاته ) مصطلح النقد الحديث .
ثنائية الداخل والخارج :
إن التحولات في السرد من الخاص ( الأم ) إلى الدائرة الأوسع بقليل للجارة ، ثم الأوسع إلى الصديق ومنه إلى الوطن ، واستعراض العلاقات المتوالية ، والتحولات المعيشية والأخلاقية والأيدلوجية وهكذا تقوم على الأساس التبادلي مع الصوت الخفي وبروزه ، والذي يفترض في القارئ صفة التفاعلية ، بأن يوجهه للنص التساؤلات المطلوبة لتبرير تلك التحولات المنظورة ولتبدو منطقتها .
إذن ، فثنائية الأصوات في حركة السرد تمثل الداخل ( الصادر ) إلى الخارج ( المتلقي ) ومسؤولة عن التحولات المتوالية من شخص إلى آخر ، ومن ضلع إلى ثاني ، ومن منطقة شعور إلى أخرى ، ما يجيز للنص طرح التساؤل كتساؤل مشروع ومبرر لبلورة الوحشة من جهة ، ومن جهة أخرى إتاحة الفرصة للطرف الخفي البروز و الفاعلية كهدف للغاية الجمالية .
وتبدو ثنائية الداخل والخارج واضحة المعالم على سبيل المثال لا الحصر في مطلع القصيدة ( المقطع الأول ) وبتوالي الشخوص في الضلع القاعدي من النص ، فالجملة الرئيسة ثم الانتقال المفاجئ للمثال على تفاعلية الوحشة في نفس الشاعر ، تجعل من الفجوة متخيلا لتساؤل القارئ ، كيف ؟ ، ليكون ( بأن أغض الطرف . . . ) .
كذلك في الانتقال من الجملة الرئيسة ( لي ما يبررها ) إلى الأسباب للوحشة بواسطة حرف العطف ( الفاء ) وهو يعني الترتيب مع التمهل ، لتكون مسافة التمهل هي المسافة المطروحة للصوت الخفي ( القارئ ) للظهور والتساؤل لمنطقة التحول من الشكوى إلى التعليل ، وتبدو هذه التقنية من النص متكررة في أكثر من موضع ما يؤكد على ما ذهبنا إليه من العملية التبادلية في الأصوات ، فإن كان النص يبدو فيه الصوت كصوت منفرد إلى أن المسافات الملاحظة تجعل من وجود صوت آخر مبررا ومنطقيا للتحول الآمن .
ثنائية الخارج والداخل :
فإنها باعثة على كشف مناطق الوحشة ، والمراد بها حمل هذه المنطقة كانتقالية انفعالية لنفس القارئ / المتلقي ، ( ونقصد بها الملابسات التاريخية والاجتماعية المحيطة بالنص الأدبي ) د. أحمد على / الموقف العربي ـ فالنص يقع بين طرفي الخارج والداخل ، بين موطني النص ، المنفى والأم ، وبين حميمية المشهد المُتَذكر و برودة وقسوة الواقع المعاش ، وبين مشاعر التحول الداخلي للوطن الأم ، والثبات والاستقرار في الوطن المنفى ، ليكشف لنا أبعاد الوحشة وقوتها في نفس الشاعر ومنها للمتلقي / القارئ ، التي تجعل من المنطقي عدم استمتاع الإنسان بالاستقرار والجمال بين عناصر المشهدين ( الابنة / ابنة الجارة ـ الحديقة / الأرض الزراعية ـ البيت / الوطن ) ، كل هذا لينتقل به إلى التحولات وعدم الاستقرار كمشهد تقابلي للأم والجارة وابنتها والصديق والحبيبة ، وانتهاء بالمراوغة من أجل البقاء ولو على حساب الرفيق ومصدر الرزق الأساسي .
فمقارنة الأم / الوطن والموصوفة ( الصمم ـ العمى ) والوطن المنفى الموصوف بـ ( الورد والابتهاج وأفراخ الحمام / السلام تقابلية تبرز الوحشة والحزن الدفين كمنتج للوحشة والآخذ معه المتلقي / القارئ إلى نفس المقارنة بين الخارج والداخل للوقوع في نفس منطقة الوحشة والنتيجة الأكيدة من الحزن .
ثنائية التراتبية :
والنص يبدأ من داخل النفس البشرية كقاعدة انطلاق في كشف الوحشة ، والتي هي في حقيقة الأمر السمة الغالبة على الوطن الأم ، والمتفجرة من نفس الشاعر كبديل شرعي لضمير الوطن الأم في المنفى ، لينتقل بعد ذلك في المقابل من الأم كعلاقة الدم بينهما وبين النفس الشاعرة للوحشة ، ولتتحول إلى الدائرة الأوسع تخص الجارة وابنتها ومنها إلى الحبيبة ومنها إلى الصديق ثم انتهاء بالنظام مع العلم ومع الجمهور ( الشعب ) إلى نهاية المطاف بالعلاقة بين هذا النظام وأفراد شعبه القائمة على الشك والمراوغة .
إذا فمجموع العلاقات الناشئة من الداخل والخارج /الخارج والداخل تشكل الخريطة السردية في النص ، وتكشف في آن واحد مجمل أسباب الوحشة وأبعادها ، والانتقالية الانفعالية كغاية جمالية وهدف مشروع للنص ، كما أنها تعطي تصورا لنوعية الحياة التي يعاني منها الوطن الأم مقابل نوعية الحياة في الوطن المنفى الذي يعيش فيه الضمير الممثل لهذا الوطن / الشاعر ، كنبرة ألم مشروعة تحيل القارئ / المتلقي إلى الانزياح المعنوي لما يجب أن يكون عليه انطلاقا مما هو كائن إلى الوصول إلى ما ينبغي أن يكون أو إلى الحلم ، وانطلاقا من رفض ضمني للواقع والأمل في الوصول إلى المثيل للوطن المنفى .
ولا تتوقف التقابلات التراتبية عند الخطوط العريضة والعامة للسرد ، بل تكون وجها أساسيا في التحولات الداخلية للموقف الواحد كعامل حاسم وبامتياز لكشف قسوة الوحشة النابعة من قسوة المحاولات للهرب من المأزق / الواقع ، فعلاقته بالأم قائمة على عدم الكف ثم التوالي في الإرسال بالرغم من الفقد ( تشتكي صمما / وقد عشيت ) ، والجارة تبدأ من ( باعت إلى المقايضة ثم الشراء وصولا لشح المصدر ) كنتيجة تلقائية لهذه التراتبية في النص والتحول من مجتمع إلى مجتمع ، ومن نشاط اقتصادي قديم إلى نشاط اقتصادي جديد مجهول الإبعاد غيير مدروس ( الخراف شحيحة ) ما يجعل هذه التحولات فاقدة للرؤية والتعقل ، وموحية بالتعجل للهرب من المأزق / الواقع حسب قدرة الهارب عقليا وعلميا وماديا .
الثنائيات التناقضية :
وقد بلع عددها خمسة عشر تناقضا ، وتستطيع من خلال هذا العدد تحدد مدى اعتماد النص عليه كاستراتيجية تستطيع هي الأخرى الكشف عن حدّة التحول وبالتالي قسوة الوحشة في النفس ومنها للقارئ ، وهي هامة نظرا لاعتمادها على الجزئية الكاشفة عن الحدة في الموقف والتحول ، لتكون مرآة عاكسة للتحولات الداخلية في النفس ، كما في مطلع النص ( غض الطرف / الابتهاج ) فالابتهاج نقطة جذب عالية لأي نفس ،فإن كان المقابل متناقضا معها ( التغاضي ) فالانزياح المعنوي الحتمي لهذه الثنائية إدراك حجم وقوة القسوة للوحشة في النفس ، وبالتالي الإحساس بمدى وحجم التوتر الانفعالي داخل النص ومنه إلى خارج النص / المتلقي .
وتتوالى الثنائيات التناقضية كأساس لمبعث السخرية من الواقع وكصفة أساسية للمأساة المولدة للملهاة ، والتزاوج الثنائي أيضا لا يبعث على الوحشة فحسب وإنما رفضها أيضا رفضا ضمنيا ، وبالتالي الدفع للبحث عن البديل المتخيل كنتيجة حتمية وحيدة يبعثها انتهاء المشهد التقابلي باللغة التأملية مقابل اللغة السردية السابقة عليها .
يبدو هذا جليا في اعتماد النص في الكشف المتوالي من الدائرة الصغرى للعلاقات وصولا إلى الدائرة الأوسع والكبرى لهذه العلاقات ، فالتناقض جليا بين موقف النفس وبين حالة الأم / الوطن ( الاتصال / الصمم ـ إرسال التصاوير / العمى الليلي ) وهي صورة ساخرة للفعل وليس من الفاعل مقابل المفعول به ، ليصبح التساؤل مشروعا ( لماذا لا أكف ) لينصب كله كدافع للتساؤل عن حقيقة الواقع المتردي .
الثنائية التضادية :
ولا نبالغ إذا قلنا إن هناك توازنا بين ثنائيتي التناقض والتضاد ، بل اعتبار التضاد جسرا للتناقض وفاعلا حاسما في تكوينه ، لذا فإننا سنجد أن الصورة للمشهد تعتمد دائما على تواجد التضاد لتوالد التناقض كثنائيات متوالية ، فالوحشة تتضاد مع الصباح دلاليا ما يجعل من مشروعية البحث عن الأسباب شيئا منطقيا وداعيا لسخرية المشهد ككل وعلى جميع مستوياته الثنائية فتناقض داخلي ( من الداخل أمام الداخل ) وخارجي ( من الداخل أمام الخارج ) وتأملي ( من الخارج إلى الداخل ) وبذلك تصبح الشبكة الداخلية للنص القائمة على العلاقات داخل الشكل المستطيلي بين أضلاعه الأربعة ومحوره النفس ، أو في العلاقات بين السبب والنتيجة داخل الضلع الواحد .
ولعل مشهد علاقة الصديق والنظام أو الفرد بالنظام والنظام والمجتمع والعلم معا ، ثم حكاية حمادة الحمار / جحا تنبي عن توكيد لهذه العلاقة بين ثنائيتي التناقض والتضاد واعتبار الثانية جسرا للأولى والأولى نتيجة حتمية للثانية والاثنان معا مكونان لمشهد ساخر حد البكاء والضحك معا .
فمحمود ( بات حرا ) بعدما ( كان متهما ) إذ قد ( ثبتت براءته ) فالنتيجة بناء على مروره لمنطقة التناقض للحرية ، ثم تحول حديثه للسخرية طبيعية لمروره السابق ، حيث ينصب حديثه حول ( التقدم / للوراء ـ تراجع / للأمام ) ليقنع بالتناقضية الموحية بأثر الواقع التناقضي والذي عاشه أو يعيشه المجتمع أيضا ، حتى يبلغ قمته بالرضا التام / الاستسلام ، والبعد عن الجميع خشية الوقوع في التضاد ( الحرية / السجن ) فيجمع التناقض في ( لا تبلغ / سلامي ) .
و يأتي المشهد الأكثر سخونة وحركية وفكريا ، ولإسقاط الحكاية الشعبية الأسطورية كثنائية من الداخل إلى الخارج من الواقع للحكاية ، مع تبادل للأدوار بين ( حمادة / حجا ) وبين الحمار ، فالأول يصبح حكيما والثاني متهورا أحمقا .
هذه المشاهد السابقة المتوالية والتي تعكس حقيقة العلاقات بين شرائح المجتمع / الشعب بالنظام المسيطر ما كان لها أن تكون بالغة الأثر إلا باجتماع هذه الثنائيات جميعها ، وبين الفعل ورد الفعل المعاكس حتى يكون المتلقي جاهزا للعملية الانتقالية للانفعال كغاية جمالية وهدف مشروع للنص والتي على أساسها أسقط النص آليات البلاغة التقليدية .
هشام مصطفى
شاعر وكاتب مصري