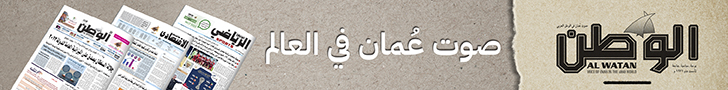إن التفاعل الذي يحدث بين الإنسان ومجاله الحيوي، لا يمكن أن يحدث إلا إذا وجد عنصران أو أكثر يسببان هذا التفاعل وهما: التكوين الطبيعي للكائن الحي البشري وما يولد به من دوافع تدفعه إلى أنماطٍ مختلفة من السلوك ليلائم بين نفسه وبين البيئة من حوله، والعنصر الثاني هو البيئة الطبيعية والاجتماعية من حوله، ويمكن أن نرى نتيجة هذا التفاعل واضحة فيما يصدر عن الإنسان من سلوك، سواء أكان قولاً أو فعلاً أو رأياً أو تعديلاً أو تغييراً في مظاهر البيئة نفسها، وهذا التغيير أو التعديل هو نتيجة طبيعية لتفاعل دوافع الفرد مع عناصر الطبيعة المختلفة والمجتمع الواحد الذي يعيش فيه.
وقد يختلف العلماء فيما بينهم فيما يطلقونه من أسماء على هذه الدوافع التي تدفع الإنسان إلى أنماط السلوك المختلفة، إلا أنهم جميعاً يؤمنون أن هناك ما يدفع الإنسان إلى السلوك، وهو ما يسمى في علم النفس بالدافعية أو القوة الدافعة أو المثير أو الدافع.
فسواء سُميت تلك القوة بمصطلح الدافع أو الباعث أو الحافز أو غير ذلك، فهي في مجملها »عوامل ترغب العاملين في القيام بالعمل، وتشحذ إرادتهم لإبداء أفضل ما يستطيعون من عطاءٍ وإنجاز«.
وتلك الدوافع تنقسم إلى دوافع اجتماعية، ودوافع فردية دنيوية، ودوافع فردية أخروية.
فالدوافع الاجتماعية ليست غريزية مخلوقة بفطرة الإنسان، ولا هي نتيجة حتمية للنمو، وإنما هي تكتسب بالتعلم أثناء التنشئة الاجتماعية للفرد وتحت تأثير عوامل الحضارة، وتجارب الحياة التي يمر بها الأفراد.
ومن هذه الدوافع التي تدفع الفرد للتفاضل العملي وتحثه على منافسة الآخرين من أبناء مجتمعه، دافعا التقدير الاجتماعي،والمكانة الاجتماعية.
فالإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش بمفرده، وحتمية تعايشه كفرد من جماعة ينتمي إليها تفرض عليه السير وفق ما تملي عليه تربية ذلك المجتمع الذي يعيش فيه.
فالتربية هي السبيل الأول في تكوين دافع تقدير واستحسان الآخرين لدى الفرد، فتتجه أعماله نحو إشباع هذا الدافع الاجتماعي، بالتفوق والمنافسة والإتقان.
والحاجة إلى التقدير دافع يكبر عند الإنسان، ويزداد اهتمامه به، بحسب مساحة البيئة الاجتماعية التي يدركها.
فالطفل مثلاً حاجته إلى التقدير وإلى إثبات ذاته تتبين في محبته لمن يهتمون بأمره ويقدرون رغباته... ثم يكبر الطفل ويزداد ميله للتقدير ممن هم حوله في المدرسة من أقرانه ومدرسيه، فيبذل الكثير ليحظى بهذا التقدير، فيعمل ويجد وينشط في مجالات كثيرة في الدراسة، حتى يلفت إليه الأنظار ويحظى بالتقدير الاجتماعي المرغوب، وقد يتمثل تقدير الفرد في إثابته أو مدحه أو الثناء عليه أو غير ذلك من أوجه التقدير.
ثم تكبر تلك النظرة عند البالغين، حيث يميل الفرد إلى أن يثاب على عمل أجاده، أو مشروع قام به، إثابة مادية كالحصول على علاوة من رئيسه، أو على درجة تشجيع أدبي، كما هو الحال في جوائز الدولة، أو استلام شهادة أو وسام أو غيرها من أوجه التقدير التي يحتاج إليها الفرد ويسعى لتحقيقها جهد الطاقة والعمل المتقن.
والتقدير الاجتماعي له صلة وثيقة في تأكيد الأمن النفسي للإنسان، وهذا يوفر له الشعور بالحب والانتماء لمجتمعه، مما يدفعه ذلك إلى المزيد من العطاء والدخول في ميدان العمل بروح ومعنويات عالية وتنافس شريف.
أما الحرمان من هذه الحاجة يشعر الفرد بالعزلة والاغتراب واحتقار الذات، فيكره ذاته، ويحقد على مجتمعه، ويصبح دائم القلق والتوجس، مما يرجع ذلك بالسلب على العمل ونوعية العمل.
فلذلك كانت فائدة المحمدة الصحيحة والثناء الصادق، والشكر على العمل واضحة، وأثرها على التربية والإصلاح القومي والشخصي ظاهر، فإن حب المدح إحدى غرائز البشر الناهضة بالهمم والمحفزة للعزائم على إتيان الأعمال العظيمة النافعة.
على أنه ينبغي أن يكون أثر حب الثناء لا يتجاوز التشجيع على المزيد من العمل، بحيث لا يصل إلى أن يكون الثناء مقصوداً لذاته.
ففي الإسلام يجب أن يسعى الإنسان لنيل مرضاة الله أولاً، فيراعي نظر الله إلى عمله قبل نظر الناس، كما قال تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وهذا لا يتعارض مع حرصه على بقاء سمعته مشرقة الجوانب بثناء الناس وتقديرهم له، والفرق أن الكافر والمنافق لا يهمه إلا نظر الخلق؛ يتوسل إلى نيل المحمدة عندهم بكل وسيلة، بينما يجعل المؤمن مدح الناس وثناءهم ثمرة من ثمرات عمله، وتلك عاجل بشراه، إذا بلغه شيء من ثناء الناس حمد الله عز وجل.
ومن أجل الحفاظ على التقدير الاجتماعي، وصيانة الشخصية الاعتبارية، يقف الإسلام موقفه الحازم ضد كل متنطع تسول له نفسه تشويه صورة أي فرد من أفراد المجتمع، برميه بالشبهات والتهم دون دليل أو حجة دامغة يقول الله عز وجل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.
ويقول أيضاً عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
فالشخصية الاعتبارية لكل فرد في المجتمع الإسلامي مصونة، وسجلها محفوظ من كل عبث، ما دام صاحبها يسمو بنفسه في مدارج الكمال والرفعة بالعمل الصالح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيما) . وهذا أعظم وسام يطمح إليه المسلم، وأعلى شهادة يتمناها أما إذا سولت النفس لصاحبها بالانحراف والخروج عن قيم المجتمع الإسلامي وعاداته الصالحة إلى ميادين الفسق والرذيلة، فإن المحمدة والثناء -بصفتهما وسام المجتمع التقديري- ينقلبان إلى مذمة وهجاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( حتى متى ترعون عن ذكر الفاسق، هتكّوه حتى يحذره الناس(والإمام جابر بن زيد رضي الله عنه لما سُئل عن غيبة الرجل الكاذب والغاش لأمته قال: »ألا لا غيبة لكل مهتوك الستر، ولا حرمة له عند رب العالمين، فكيف عند المخلوقين«.
فرقابة المجتمع عادلة، وأحكامها صارمة، تقدّر من يستحق التقدير، فتدفعه دفعاً حثيثاً إلى مزيد امتياز وتفوق، وتهتك ستر كل متقاعس عن السمو بالنفس إلى مراتب العلا.
كدلك المكانة الاجتماعية إحدى الدوافع التي تتحكم في النفس البشرية وتحفزها إلى المزيد من الجهد والإتقان للعمل الذي تقوم به.
وفي السياق القرآني يقص علينا عز وجل في سورة الأعراف قصة فرعون مع السحرة، وكيف استعمل فرعون المكانة الاجتماعية والتقريب إليه دافعاً أكبر في شحذ همم السحرة ودفعهم بقوة لمواجهة نبي الله موسى عليه السلام، إذ يقول عز وجل: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
فالتقريب إلى فرعون حافز أعظم للسحرة من حافز الأجر الذي كانوا يطمعون به، ولهذا أكد عليه فرعون وجعله الجائزة الكبرى لهم، لمعرفته بخبايا نفوس بني جنسه.
والناس في سعيهم لكسب المكانة الاجتماعية يختلفون فيما بينهم، والفرد يستمد معاييرها من جماعة يحاول أن يقارن نفسه بها ويسعى لاكتساب الميزات التي جعلت لها المكانة.
فقد يسعى طالب أن يكون طبيباً كوالده أو مثل عمه، وقد تسعى أسرة ما إلى تعليم أبنائها حتى تكون في مستوى أسرة معروفة، وقد يسعى فرد للحصول على المال لكي يكون في مستوى شيخ العشيرة. بل إن المقارنة لا تتوقف عند حد اقتباس معايير المكانة فقط. بل تشمل أيضاً مقارنة النفس بالغير للتأكد من امتياز الفرد عن هذا الغير.
لذلك تجد الإنسان السوي لا يرتاح أبداً ما لم يحقق ذاته وطموحاته في واقع حياة المجتمع، ويتقدم درجات يشفي بها غليله المتعطش للمركز الاجتماعي، كنتيجة يقرها الإسلام لكل صاحب كفاءة.
فقد ذُكر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ ننزِّل الناس منازلهم. وهذا يدل صراحة على التقدم والتأخر بين أفراد المجتمع، ووجود المنازل المتفاوتة التي يفرض وجودها نظام عمارة الأرض والخلافة فيها، فكل صاحب تقدم عملي أولى بالمنزلة العالية من غيره.
ومكافأة العامل في الإسلام تقدر بمقدار المنفعة التي يقدمها، وحسب بلائه وطبيعة عمله، فكلما ظهر تفوق العامل إنتاجا وإبداعاً ازداد أجره وارتفع منصبه. فيعطى العامل الجيد أكثر مما يعطى العامل المتوسط، ويعطى المتوسط أكثر مما يعطى الخامل الكسلان... إذ تقدر قيمة العامل ومكانته في المجتمع الإسلامي بحسب جهده وكفاءته وإنتاجه العملي، وهذا من عدل شريعة الإسلام الخالدة التي جاءت تتعامل مع الإنسان كجسد وروح، والجزاء من جنس العمل، ولا بد لكل إنسان من أن يحصد ثمار جهوده، وأن ينال ما يستحق من مكانة اجتماعية بحسب جده وإتقانه. قال تعالى: لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا.
دـ سيف بن أحمد البوسعيدي
وقد يختلف العلماء فيما بينهم فيما يطلقونه من أسماء على هذه الدوافع التي تدفع الإنسان إلى أنماط السلوك المختلفة، إلا أنهم جميعاً يؤمنون أن هناك ما يدفع الإنسان إلى السلوك، وهو ما يسمى في علم النفس بالدافعية أو القوة الدافعة أو المثير أو الدافع.
فسواء سُميت تلك القوة بمصطلح الدافع أو الباعث أو الحافز أو غير ذلك، فهي في مجملها »عوامل ترغب العاملين في القيام بالعمل، وتشحذ إرادتهم لإبداء أفضل ما يستطيعون من عطاءٍ وإنجاز«.
وتلك الدوافع تنقسم إلى دوافع اجتماعية، ودوافع فردية دنيوية، ودوافع فردية أخروية.
فالدوافع الاجتماعية ليست غريزية مخلوقة بفطرة الإنسان، ولا هي نتيجة حتمية للنمو، وإنما هي تكتسب بالتعلم أثناء التنشئة الاجتماعية للفرد وتحت تأثير عوامل الحضارة، وتجارب الحياة التي يمر بها الأفراد.
ومن هذه الدوافع التي تدفع الفرد للتفاضل العملي وتحثه على منافسة الآخرين من أبناء مجتمعه، دافعا التقدير الاجتماعي،والمكانة الاجتماعية.
فالإنسان اجتماعي بطبعه، لا يمكنه العيش بمفرده، وحتمية تعايشه كفرد من جماعة ينتمي إليها تفرض عليه السير وفق ما تملي عليه تربية ذلك المجتمع الذي يعيش فيه.
فالتربية هي السبيل الأول في تكوين دافع تقدير واستحسان الآخرين لدى الفرد، فتتجه أعماله نحو إشباع هذا الدافع الاجتماعي، بالتفوق والمنافسة والإتقان.
والحاجة إلى التقدير دافع يكبر عند الإنسان، ويزداد اهتمامه به، بحسب مساحة البيئة الاجتماعية التي يدركها.
فالطفل مثلاً حاجته إلى التقدير وإلى إثبات ذاته تتبين في محبته لمن يهتمون بأمره ويقدرون رغباته... ثم يكبر الطفل ويزداد ميله للتقدير ممن هم حوله في المدرسة من أقرانه ومدرسيه، فيبذل الكثير ليحظى بهذا التقدير، فيعمل ويجد وينشط في مجالات كثيرة في الدراسة، حتى يلفت إليه الأنظار ويحظى بالتقدير الاجتماعي المرغوب، وقد يتمثل تقدير الفرد في إثابته أو مدحه أو الثناء عليه أو غير ذلك من أوجه التقدير.
ثم تكبر تلك النظرة عند البالغين، حيث يميل الفرد إلى أن يثاب على عمل أجاده، أو مشروع قام به، إثابة مادية كالحصول على علاوة من رئيسه، أو على درجة تشجيع أدبي، كما هو الحال في جوائز الدولة، أو استلام شهادة أو وسام أو غيرها من أوجه التقدير التي يحتاج إليها الفرد ويسعى لتحقيقها جهد الطاقة والعمل المتقن.
والتقدير الاجتماعي له صلة وثيقة في تأكيد الأمن النفسي للإنسان، وهذا يوفر له الشعور بالحب والانتماء لمجتمعه، مما يدفعه ذلك إلى المزيد من العطاء والدخول في ميدان العمل بروح ومعنويات عالية وتنافس شريف.
أما الحرمان من هذه الحاجة يشعر الفرد بالعزلة والاغتراب واحتقار الذات، فيكره ذاته، ويحقد على مجتمعه، ويصبح دائم القلق والتوجس، مما يرجع ذلك بالسلب على العمل ونوعية العمل.
فلذلك كانت فائدة المحمدة الصحيحة والثناء الصادق، والشكر على العمل واضحة، وأثرها على التربية والإصلاح القومي والشخصي ظاهر، فإن حب المدح إحدى غرائز البشر الناهضة بالهمم والمحفزة للعزائم على إتيان الأعمال العظيمة النافعة.
على أنه ينبغي أن يكون أثر حب الثناء لا يتجاوز التشجيع على المزيد من العمل، بحيث لا يصل إلى أن يكون الثناء مقصوداً لذاته.
ففي الإسلام يجب أن يسعى الإنسان لنيل مرضاة الله أولاً، فيراعي نظر الله إلى عمله قبل نظر الناس، كما قال تعالى: وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. وهذا لا يتعارض مع حرصه على بقاء سمعته مشرقة الجوانب بثناء الناس وتقديرهم له، والفرق أن الكافر والمنافق لا يهمه إلا نظر الخلق؛ يتوسل إلى نيل المحمدة عندهم بكل وسيلة، بينما يجعل المؤمن مدح الناس وثناءهم ثمرة من ثمرات عمله، وتلك عاجل بشراه، إذا بلغه شيء من ثناء الناس حمد الله عز وجل.
ومن أجل الحفاظ على التقدير الاجتماعي، وصيانة الشخصية الاعتبارية، يقف الإسلام موقفه الحازم ضد كل متنطع تسول له نفسه تشويه صورة أي فرد من أفراد المجتمع، برميه بالشبهات والتهم دون دليل أو حجة دامغة يقول الله عز وجل: يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ.
ويقول أيضاً عز وجل: إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ.
فالشخصية الاعتبارية لكل فرد في المجتمع الإسلامي مصونة، وسجلها محفوظ من كل عبث، ما دام صاحبها يسمو بنفسه في مدارج الكمال والرفعة بالعمل الصالح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ( إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيما) . وهذا أعظم وسام يطمح إليه المسلم، وأعلى شهادة يتمناها أما إذا سولت النفس لصاحبها بالانحراف والخروج عن قيم المجتمع الإسلامي وعاداته الصالحة إلى ميادين الفسق والرذيلة، فإن المحمدة والثناء -بصفتهما وسام المجتمع التقديري- ينقلبان إلى مذمة وهجاء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( حتى متى ترعون عن ذكر الفاسق، هتكّوه حتى يحذره الناس(والإمام جابر بن زيد رضي الله عنه لما سُئل عن غيبة الرجل الكاذب والغاش لأمته قال: »ألا لا غيبة لكل مهتوك الستر، ولا حرمة له عند رب العالمين، فكيف عند المخلوقين«.
فرقابة المجتمع عادلة، وأحكامها صارمة، تقدّر من يستحق التقدير، فتدفعه دفعاً حثيثاً إلى مزيد امتياز وتفوق، وتهتك ستر كل متقاعس عن السمو بالنفس إلى مراتب العلا.
كدلك المكانة الاجتماعية إحدى الدوافع التي تتحكم في النفس البشرية وتحفزها إلى المزيد من الجهد والإتقان للعمل الذي تقوم به.
وفي السياق القرآني يقص علينا عز وجل في سورة الأعراف قصة فرعون مع السحرة، وكيف استعمل فرعون المكانة الاجتماعية والتقريب إليه دافعاً أكبر في شحذ همم السحرة ودفعهم بقوة لمواجهة نبي الله موسى عليه السلام، إذ يقول عز وجل: وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ.
فالتقريب إلى فرعون حافز أعظم للسحرة من حافز الأجر الذي كانوا يطمعون به، ولهذا أكد عليه فرعون وجعله الجائزة الكبرى لهم، لمعرفته بخبايا نفوس بني جنسه.
والناس في سعيهم لكسب المكانة الاجتماعية يختلفون فيما بينهم، والفرد يستمد معاييرها من جماعة يحاول أن يقارن نفسه بها ويسعى لاكتساب الميزات التي جعلت لها المكانة.
فقد يسعى طالب أن يكون طبيباً كوالده أو مثل عمه، وقد تسعى أسرة ما إلى تعليم أبنائها حتى تكون في مستوى أسرة معروفة، وقد يسعى فرد للحصول على المال لكي يكون في مستوى شيخ العشيرة. بل إن المقارنة لا تتوقف عند حد اقتباس معايير المكانة فقط. بل تشمل أيضاً مقارنة النفس بالغير للتأكد من امتياز الفرد عن هذا الغير.
لذلك تجد الإنسان السوي لا يرتاح أبداً ما لم يحقق ذاته وطموحاته في واقع حياة المجتمع، ويتقدم درجات يشفي بها غليله المتعطش للمركز الاجتماعي، كنتيجة يقرها الإسلام لكل صاحب كفاءة.
فقد ذُكر عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ ننزِّل الناس منازلهم. وهذا يدل صراحة على التقدم والتأخر بين أفراد المجتمع، ووجود المنازل المتفاوتة التي يفرض وجودها نظام عمارة الأرض والخلافة فيها، فكل صاحب تقدم عملي أولى بالمنزلة العالية من غيره.
ومكافأة العامل في الإسلام تقدر بمقدار المنفعة التي يقدمها، وحسب بلائه وطبيعة عمله، فكلما ظهر تفوق العامل إنتاجا وإبداعاً ازداد أجره وارتفع منصبه. فيعطى العامل الجيد أكثر مما يعطى العامل المتوسط، ويعطى المتوسط أكثر مما يعطى الخامل الكسلان... إذ تقدر قيمة العامل ومكانته في المجتمع الإسلامي بحسب جهده وكفاءته وإنتاجه العملي، وهذا من عدل شريعة الإسلام الخالدة التي جاءت تتعامل مع الإنسان كجسد وروح، والجزاء من جنس العمل، ولا بد لكل إنسان من أن يحصد ثمار جهوده، وأن ينال ما يستحق من مكانة اجتماعية بحسب جده وإتقانه. قال تعالى: لا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا.
دـ سيف بن أحمد البوسعيدي