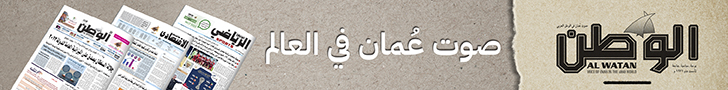عبدالله الشعيبي:
تفتح ثيمتا (القرية) و(المدينة) في النقد الثقافي الكثير من الأسئلة ذات السمات المقارنة، على اعتبار أن الانزياح الشمولي يصبّ في صالح المدينة على حساب القرية، في ظل إغراءات متسمة بتناغم بارز ومتحقق مع روح العصر، في الوقت الذي تأبى العديد من الأطراف على التمسك بشخصيتها المستقلة وعدم الانسجام مع المراكز، بمعنى التماهي إلى درجة ذوبان الشخصية القروية الطرفية في المراكز.
على مستوى السلطنة، تقوم قرينة رحلات الذهاب والإياب، ولا نقول الهجرة النسبية أو المطلقة، تقوم على أساس أن الذاهبين إلى المدينة يكونون هم جذر القرية في الحياة اليومية، وباعتبار خمسة أيام في الأسبوع في مقابل يومين، يسمح هذا الوقت بوجود تغيير وتغير منهجي وتدريجي في الشخصية الواحدة، مع التسليم بوجود نسقين مختلفين للمكانين (القرية والمدينة)، مع وجود قواسم مشتركة بينهما كذلك، ومع هذا فإن الدافع الرزقي (لقمة العيش) تكون سببا في التغيير والتغير، وهو ما يقود أحيانا إلى التمرد على السابق في مقابل اللاحق ، أو التوازن بينهما، أو الإنفصال الجزئي أو الكلي عن المكان (القرية) لصالح المكان الآخر (المدينة)، وهو ما سيفتح الباب لرياح الأسئلة.
تقاسيم وأزمنة
بالنظر إلى التقسيمات الجغرافية التي تتميز بها السلطنة، والتي لم تتغير بين قديم الزمان وحديثه، وبالنظر إلى التحول الذي نقل بعض أجزاء هذه التقسيمات من شكل سابق إلى شكل آخر، ومن تغيير جوهري شمولي في التعليم والصحة والعادات والتقاليد والحراكات اليومية والتواصلات المجتمعية وأشكالها، يمكن القول إن الأنساق التي غلبت على المكان قبل خمسين سنة وما قبل، تختلف عما آلت إليه في الخمسين سنة التالية، وهي المقترنة بقرنين من الزمان، وهما القرنان العشرين والحادي والعشرين، وهذا الاختلاف يفسح المجال للوقائع والقرائن والمشاهدات كي تنظر بعين المقارنة بين ما كان وما صار الحال إليه.
فالنسق العام الذي ينظم الحيوات بمختلف أشكالها في البيئة العمانية القديمة، بكل ما يشير إلى شخصية المكان والإنسان الحالّ فيه، مرتبط بمراحل ظلت تكرر ذاتها، من دون أن تخرج من تلك المراحل نحو أفق مختلف، فتضاريس الجبال والرمال والسواحل ظلت على حالها، ولم تتغير خارطتها البصرية، وظلت الأجيال تتوارث السمات البصرية المشتركة للأماكن، باعتبارها امتدادا ثابتا لا تغيير فيه، وهو ما ساعد على تجذير وتقوية أصالة النسق الذي يميل إلى تنميط كل شيء، السلوكيات والعادات والتقاليد، من دون تمرد عليها أو رفض معالمها، وبالتالي ظلت تنحفر بمختلف أشكال التلقين، البصرية والسلوكية والقولية.
هذا التوافق على التجذير، الذي استمر عقودا طويلة، كان كفيلا بجعل كل جديد بمثابة عنصر مهزوم، لن يلبث أن يتراجع ، لأنه لا يسير على السويّة الجمعية المألوفة والمتجذرة، والتي صارت نسقا جاذبا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
لهذا، ظلت القرية، متجلية بشخصيتها العصية على التغيير، وشكّل نسقها بُعدا في الشخصية الفردية ونسقها الجمعي الغالب والقارّ، مما جعلها ممتدة أفقيا وعموديا، مكانيا وبشريا.
نزوح مزدوج
عندما تشكّلت المدينة بأبعادها المختلفة، المتحققة من خلال : البيوت المبنية بنمط معماري مختلف، الأسواق الكبيرة، التعدد الديموغرافي للعناصر البشرية، فضلا عن انسلاخ المدينة من الرتم التقليدي للحياة اليومية، إلى الرتم السريع ذي خاصية المصالح المشتركة، حصل تطور كبير في مسألة الجذب البشري، باعتبار أن المدن بمثابة مراكز استقطابية وجاذبة، فصارت طرفا منافسا للنسق القروي في الأطراف، وما احتاجت التغييرات إلا مراحل زمنية بخطة تدريجية، حتى تصبح ذات تأثير بالغ على الأفراد، وهو مناط التحول النسقي في المكان الواحد، يمكن قول هذا على مستوى التحول الذي تميزت به ولايات صور ومسقط وصحار وغيرها من المدن ذات الحس الجذبي.
هذه التشكيلات الحياتية البارزة، أنمت حدسا خاصا لدى الفرد المنضوي تحت يافطة النسق الجمعي، وهو النزوح نحو المدن، وهنا تعددت المدن، منها ما هو داخل السلطنة، ومنها ما هو خارجها، وإن كانت الفكرة مبدئيا هي الهجرة من أجل العمل، لكنها تطورت بمرور الوقت، ليصبح نزوحا بهدف العمل والتغيير، تمهيدا للانتقال والاستقرار.
يمكن القول هنا بأنه لا توجد مرجعيات إحصائية حول كم هذا النزوح المزدوج، فهو نزوح من القرية إلى المدينة، ومن المدينة إلى القرية، ولكن الأول بدافع العمل، بينما الثاني بدافع الترفيه والتغيير والمتعة.
النزوح الأول لم يخضع لدراسات استبيانية، لفهم التغييرات التي طالت النسق، من خلال فهم التغييرات التي طالت قناعات الفرد في العلاقة بين تغليب الإرادة الفردية أو الإرادة الجمعية في خيارات الحياة التي توفرها أنساق المدينة على حساب القرية، وعلى الرغم من ذلك، فإن المرئيات التي تعكسها تلك النزوحات الاختيارية في البيئة العمانية تفتح مساحات لطرح الأسئلة النسقية، لفهم الآلية التي يفكر بها الفرد المنتمي وجدانيا إلى القرية، بينما يميل في سلوكه غير النمطي إلى المدينة، وهو السلوك ذاته الذي يخلق إشكالية في الازدواج الواعي في كون قناعاته المدينية ستتعارض نسبيا في ظل تواجد متقطع في القرية، والعكس صحيح.
جذر وريح
تفصح الأنساق في المجتمع العماني، قديمها وحديثها، عن أن العلاقة بين الجذر والريح، أي بين القارّ والمتغيّر، هي علاقة متوازنة أحيانا، ومتوترة أحيانا أخر، خاصة في ظل مكتسبات سلوكية ومعرفية جديدة، تنعكس على الأجيال الجديدة التي وجدت نفسها في بيئة مختلفة من حيث القيم والعادات والتقاليد، ما بين كونها جزءا من الشخصية الفردية الذائبة في البيئة الأكبر (المجتمع)، وكونها مستقلة من دون مرجعية واضحة، باستثناء مرجعية الخيار الذاتي في مختلف القرارات والتواصلات وبناء الأفق المستقبلي، وما ينعكس من وراء ذلك على مرايا السمات النسقية المتحولة، والتي تعبر الآن من دون أن يشعر بها أحد ، ريثما تصبح - هي الأخرى- قارّة وحالّة، مشكْلة مرحلتها وهويتها.
هل نحتاج إلى أسئلة بحثية لقراءة ذلك كله أو مقاربته على أقل تقدير؟
أظن أن التحول سنْة كونية، والتعايش والتكيف مع المستجدات أمر لا محيد عنه، ولكن من الضروري - من أجل فهم أعمق للتكوينات والمسارات النسقية - فتح المجال للدراسات الاجتماعية والنسقية والإحصائية بأن تمارس دورها البحثي الطبيعي، في ظل وجود بيئة قابلة للمعاينة والمقاربة، لفهم التحولات التي شكلت متغيرات الثقافة الجمعية، وعلاقتها بالجذور السلوكية والقيمية، وصلاتها المباشرة أو غير المباشرة بالعلاقة بين القرية والمدينة في البيئة العمانية..
خاتمة
عمليا، هذا الموضوع الذي يحاول مقاربة الصلة بين المدينة والقرية في المكان العماني، وعلاقته بالأفراد وتشكيل الثقافة الجمعية الجديدة، هو في حد ذاته مطلب ضروري وملحّ، بل نظن أن إغفاله هو قفز على جوهر النسق القديم وشكله، وقطيعة لا ينبغي الانقياد لها، ذلك أن طبيعة البيئة العمانية مذيبة التغييرات، إلى درجة يصعب معها - بالتقادم - الفصل بين ما كان وما صار ، لولا وشاية الفلكلور، الذي يطرح أسئلته حول الماهيّات التي شكلت المراحل السابقة، وشكلياتها الكينونية، و جوهرها الذي من خلاله تشكلت الشخصية العمانية، بخواصها ومتناقضاتها.